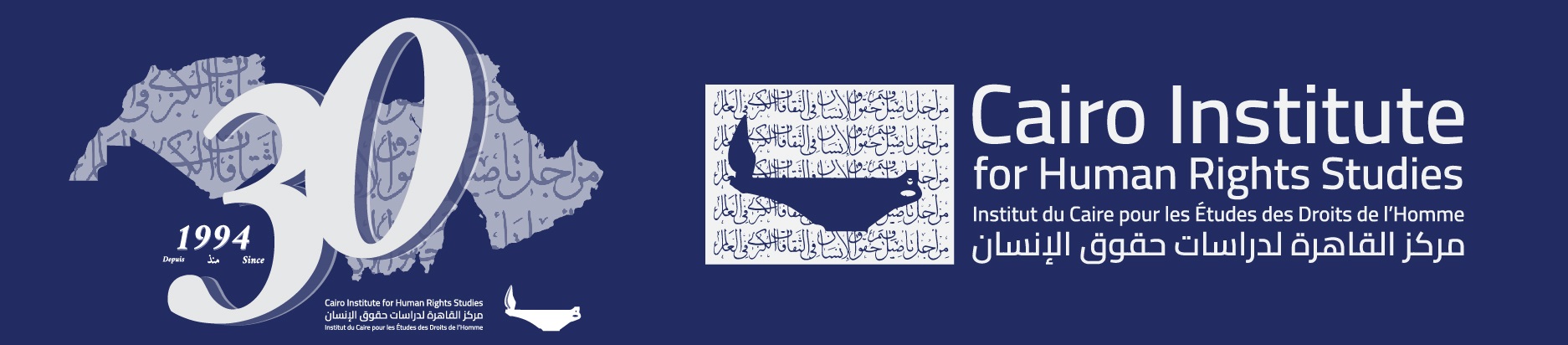محمد سيد سعيد
جريدة البديل، 20 سبتمبر 2008
برنامج للإنقاذ الوطني وليس التوحد الأعمي خلف رئيس
الصعوبة الحقيقية في الجمع بين الديمقراطية والنهضة
يبدو أن رأس القاهرة صارت خفيفة. فهي تدور كل يوم حسب الريح وتبحث كل يوم عن حل مريح.
آخر “الحلول المريحة” ينادي المعارضة المصرية بالاتحاد خلف “الكتلة الصلبة” للدولة المصرية كطريق للخروج من المأزق السياسي الذي نعيشه اليوم.. وهو حل مريح مثلما الانتحار “حل مريح ونهائي أيضًا”. وكان سوء الفهم قد مهد لهذا الحل الانتحاري لفترة طويلة، وللأسف في الوقت الذي كان النضال من أجل الخلاص الوطني قد بدأ يتدفق خلال عامي 2004 و2005.
المشكلة كانت ربما في تعريف المأزق السياسي.
للأسف كانت النخبة السياسية المصرية قد اختزلت المأزق السياسي في احتمالات توريث السلطة من الرئيس لابنه. واليوم وكلما تقدم الرئيس في العمر وخفت قدرته على العمل اليومي وعلى ضبط أداء السلطة برز هذا المأزق بصورة أشد. ولكن هذه الحقيقة لا تنفي أن التشخيص كان مختزلا وتبسيطيا بل وعليلا هو بذاته. فالمأزق كان دائمًا وفي كل وقت وفي هذا الوقت بالذات كامنا في معني السلطة التي تورث وليس فيمن يتم توريثه. ومع كل يوم يبدو أن الاختزال الذي قامت به النخبة السياسية المعارضة يزداد كثافة حتى صار القلق يستبد بها على “مصير الدولة المصرية”، وكأن مجرد الرمد قد تحول إلى عمي ألوان ثم تدهور إلى عمى دائم. فلم تكن هناك أبدأ مشكلة للكتلة الصلبة للدولة.. بل كانت هناك دائما مشكلة في التدمير والتحلل المفروض من أعلي على المجتمع.
بين الجمهورية والمملوكية
وبذلك تكون المسألة السياسية في مصر قد قلبت تماما ووضعت على رأسها.
كانت هناك مشكلة فكرية وثقافية وعملية في اختزال قضية مستقبل البلاد في مشكلة التوريث. وقد نبه كثيرون لحقيقة أن توريث السلطة من الأب للابن كارثة حقيقية. إذ هي تلغي فعليًا واحدًا من أهم إنجازات النضال ضد الاستعمار وهو إعلان الجمهورية. ولكن المشكلة الأكبر لم تكن فيمن يتم توريثه بل في مبدأ التوريث ذاته.
توريث السلطة من الأب للابن يسخر من إعلان الجمهورية ويحيل بلادنا لنظام ملكي أو سلطاني.
ولكن حقيقة الأمر أننا –المجتمع والشعب المصري– لم نناضل حقًا من أجل الجمهورية ولم نمنح هذا المصطلح قيمته العاطفية ومحتواه السياسي الحقيقي. ولذلك صار التوريث أمرًا اعتياديًا ومعمولًا به “في ظل الجمهورية” بل ولاغيًا لها في الواقع.
“الجمهورية” ترجمة لمصطلح سلطة العامة: أي الشعب. والسلطة تمتحن بطريقة توليتها. فإن كان الشعب قد خرج من المعادلة ولم يكن أبدًا قادرًا على تولية السلطة لمن يشاء في انتخابات حرة نزيهة تعددية وذات برامج يكون قد تم إلغاء الجمهورية فعليًا.
لم يكن هذا النظام ملكيًا وراثيًا على النحو الذي شهدناه في عهد أسرة محمد علي. وإن شئنا أن نسميه باسمه الحقيقي والمستمد من تاريخنا، فهو في الواقع كان نظاما “مملوكيًا” تفوض فيه “كتلة قوة” رأسًا لها بممارسة سلطات كبيرة للغاية وجزئيًا تحت إشرافها. العجيب في هذا النظام أنه صار النموذج المعتمد للفكر السياسي والدستوري في مصر دون أن يكون أحد قد فكر فيه أو تأمله للحظة واحدة. لقد فرض نفسه في غيبة التفكير… بما في ذلك تفكير المماليك أنفسهم. فحتى بالنسبة لكتلة القوة تصبح ماكينة السلطة هي الأمر المهم ولو داست أو هرست أو دمرت أو أفسدت من يمارسها شاء أم أبي!
الغرغرينا أم الصداع
الدعوة للاتحاد خلف “كتلة القوة” أي في الواقع “كتلة السلطة” تدعونا لمعالجة صداع بسيط مع ترك الغرغرينا تمتد من الأقدام إلى القلب وبقية الجسد.
وخارج قضية التوريث تبدو الدعوة وكأنها تعبر عن قلق عجيب نحو مشكلة مفتعلة تمامًا وهي “مشكلة الانتقال الآمن للسلطة”. وقد تكون هذه مشكلة الأمريكان أو العرب أو النظام الدولي. لم تحدث مشكلة في الانتقال الآمن للسلطة في ظل أسرة محمد علي. ولم تحدث مشكلة في الانتقال الآمن للسلطة في “ظل الجمهورية”. فانتقلت السلطة بنفس طريقة التوريث السياسي وعن طريق نفس كتلة القوة –السلطة– من رئيس لآخر مرتين من قبل دون أدني اضطراب.
المشكلة كانت دائمًا في أن هذا الانتقال الآمن للسلطة تجنب المرور على كيان مهم، بل الكيان الذي تمارس السلطة باسمه: وهو الشعب أو المجتمع. كانت السلطة تتحدد بمعناها ومبناها وبمن يمارسها وبطريقته
–الشاذة أحيانا– في ممارستها دون أن يتم استشارة الشعب أو استطلاع رأيه أو حتى مجرد تعريفه على من يورث هذه السلطة.
هنا كانت المشكلة بأكثر كثيرًا مما كانت توريث السلطة من أب إلى ابن. وحتى لو تدهور بنا الحال قليلا من توريث غامض وغير محدد أي من توريث بيولوجي إلى توريث سياسي فليس هناك أدني مبرر لأن نختزل مطلبنا وموقفنا في العودة للنظام الأول حتى نتفادي النظام الثاني.
وحتي لو اتفقنا على أن المشكلة هي التوريث البيولوجي –من الأب للابن– فكيف نتأكد أن التوريث السياسي الذي تدعونا له “الكتلة الصلبة” للدولة سيكون أفضل ناهيك عن أن يكون حلًا؟ ولماذا نتحد خلف “كتلة قوة” أو “كتلة سلطة” لم تأبه أبدًا، لا باستشارتنا ولا حتى باستطلاع رأينا فيما تنوي القيام به ولم يتضح بعد أن اتضح أبدًا؟ وماذا سيكون حالنا إن وقفنا معها “عمياني كده” وقررت هي أن تورث السلطة للابن سواء بوعيها أو في غيبة هذا الوعي؟ وإن قررت أن تمنح السلطة لأي رئيس آخر من أدرانا بمواقفه أو أرائه أو سلوكياته أو أي مؤشر آخر يطمئن أبسط الناس على رجاحة عقله أو حتى سلامته النفسية؟
وكانت مصر المسكينة قد شهدت عمليات توريث للسلطة إلى “حالات نفسية” وعصبية عرضتها لأمور مضحكة بأكثر مما تصور المتنبي في بيته الشعري الشهير.
معني السلطة ومشكلة المجتمع
هنا تظهر “الغرغرينا” الحقيقية التي تتجاهلها دعوة “الكتلة الصلبة”.
الغرغرينا الحقيقية بل السم الزعاف الذي تجرعه هذا الوطن على مدي زمني غير محدود كان دائمًا السلطة غير المقيدة.. السلطة التعسفية…السلطة التي تملك كل شيء ولا يحدها شيء…السلطة الاستبدادية التي لا تعترف بعقد أو قيمة أو مثال أو ضوابط أو قانون أو شرع أو شرعية.
ولا يمكن أبدًا أن ندعي أننا في تاريخنا الوطني واجهنا هذه المشكلة بصورة واحدة أو متساوية. فقد كان أجدادنا قد حققوا بعض التقدم على طريق بناء الدولة الوطنية الديمقراطية في مصر. كان التقدم بطيئًا.. وكان مشوهًا.. وتعرض لانقلابات سياسية ودستورية.. وتعرض لما هو أسوأ أي للانقلابات الثقافية. وأغرب هذه الانقلابات تظهر في أن أكبر حركة سياسية في البلاد على المستوي الشعبي كانت تتهرب من الالتزام بالدستور الديمقراطي من أجل إقناعنا بوهم الخلافة: التي هي سلطة استبدادية مطلقة وغير مقيدة!
كل ذلك صحيح. ولكن صحيح أيضًا أن بلادنا كانت تخطو بالتدريج على طريق بناء الدولة القانونية باسم الشعب ولو من الناحية الشكلية. بل وكان هناك توافق حقيقي على فكرة جوهرية تمثل قاعدة فكرة النهضة وهي “مبدأ حكم القانون”. ومع نهاية الأربعينيات أصبحت مصر تملك تقنينًا مدنيًا شاملًا وتملك أيضًا سلطة قضائية مستقلة وتملك الأمل في الانتقال لسلطة الشعب عبر انتخابات شعبية بعضها تم تزويرها وبعضها كان على أعلى مستويات النزاهة.
وكان الانتقال إلى الاستبداد بذاته واحدًا من أسوأ الانقلابات الثقافية في تاريخ بلادنا. والأسوأ أن هذا الانقلاب بالذات لم يكن ضروريًا ولا كان حتميًا. ففي ظل التجربة الوطنية للرئيس ناصر كان يمكنه أن يخوض انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وأن يظفر بها بدون عوائق كبيرة وإن بالتأكيد بنسبة أقل. كان سيكون زعيمًا وقائدًا للدولة المجتمع وبطلًا للشعب ولكن ليس.. إلهًا.
انقلاب أسوأ
أما الانقلاب الثقافي الأسوأ فهو أن نتجاهل هذه الخبرة المريرة التي عصفت بكل إنجازات مصر بما فيها إنجازات الناصرية. الانقلاب الثقافي الأسوأ يكمن فيما تدعونا له نظرية “الكتلة الصلبة” هذه. فمعناها أن ندير ظهورنا لخبرة أكثر من خمسين عامًا من التجربة الوطنية المريرة لكي نضاعف المرض ونجبر بلادنا على تجرع سم أشد باسم صداع التوريث.
خبرة خسمين عامًا تقول ببساطة إنه كان علينا منذ زمن أن ننتقل من نظام تسلطي تعسفي تمارسه “كتلة خفية” إلى نظام يقوم على حكم القانون أو حكم الشعب المنظم في مؤسسات مدنية وسياسية واعية ومقتدرة وشفافة نستطيع أن نراها وترانا نحترمها وتخشانا باعتبارنا مصدر سلطتها لا ضحيتها ولا ملكيتها.
بكل أسف لم ننجز هذه المهمة ولم تحقق الأجيال الحالية هذه الرسالة ولم نضطلع بهذه المسئولية. أما الأسوأ فهو أن يدعو بعضنا لأن نغرق أنفسنا في المشكلة ذاتها بقدر أكبر وأن ننتحر في المستنقع بدون حتى إعلان برنامج عمل أو قيمة أو فكرة ولندع الآن معني المجد!
المهمة والرسالة والتحدي كان دائما إنتاج معني جديد للسلطة. فهذا هو ما يهم وطن كامل اسمه مصر وشعب كامل هو المصريون. وبالطبع يهم هذا الوطن ويهم هذا الشعب أن يولي عنايته لقضية من يتولى رأس السلطة. ولكن القضية الأخيرة هو جزء من الأولي ومجرد تطبيق لها. فالمهم أن يتولى السلطة شخص أو أشخاص يحترمون معناها الذي نتفق عليه وعقدها الذي نبرمه وحدودها التي شرعها الضمير الإنساني وأكدها التاريخ بل وجعلتها الطبيعة حكمًا ومعيارًا نهائيًا. فلا سلطة بشرية يمكنها أبدًا أن تنهي حياة إنسان أو تعذبه او تعتقله وتحرمه من حرياته وحقوقه.
وهنا بيت القصيد.
السلطة القائمة حاليًا في مصر والتي يكمن خلفها كيان ما يسميه البعض “الكتلة” أو “النواة” الصلبة للدولة ليست فقط سلطة استبدادية مطلقة متعالية وقاسية وغير مقيدة بشيء. بل إنها مضت على هذا الطريق مسافة لم تصلها أبدًا أي سلطة مماثلة في تاريخ مصر منذ منتصف القرن التاسع عشر.
فلم يحدث أبدًا أن تم انتهاك حكم القانون حتى اهترأ بالدرجة التي تحدث حاليًا.
ولم يحدث أن انتهكت أبسط حقوق الإنسان وعلي رأسها حقه في سلامة الجسد من القتل العمدي والتعذيب مثلما يحدث الآن.
ولم يحدث أن وصل تعسف السلطة إلى حد لا ندري فيه ماذا سيكون القرار في اليوم التالي أو في الساعة القادمة حيال نفس القضية أو نفس الحدث أو نفس المشكلة أو نفس الحالة مثلما نشهد الآن.
Share this Post