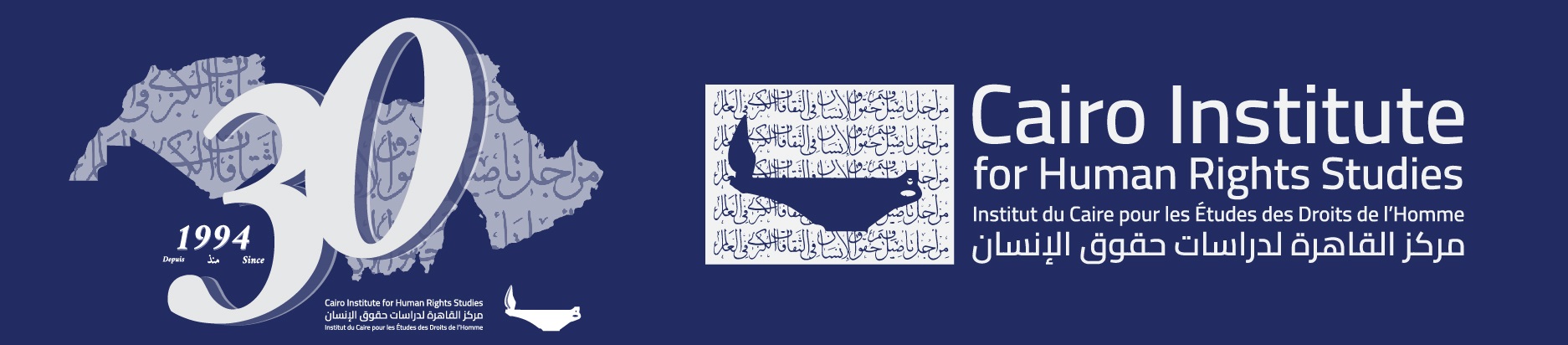يُعرب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان عن رفضه للفلسفة والرؤية التي تعبّر عنها الصياغات التي انتهت إليها الجمعية التأسيسية في باب الحقوق والحريات والواجبات العامة وباب المقومات الأساسية للدولة. إذ يتجه الدستور إلى تقييد الحريات العامة والانتقاص من حقوق الإنسان، هذا فضلاً عن عدم استيعاب نصوصه لمفهوم الدولة الديمقراطية الحديثة، والسعي لتأسيس دولة دينية تتبنى في دستورها مذهبًا بعينه يمنح المؤسسة الدينية سلطات ذات طبيعة سياسية، وتقوم الدولة الدينية بالأساس على تقييد الحريات العامة والخاصة. كما يُلاحظ تبني الجمعية التأسيسية لمواد تسمح بتعدد النظم القانونية التي تؤطر شئون المصريين، وذلك انطلاقًا من اعتبارات دينية وطائفية. وهي خطوة خطيرة في اتجاه “لبننة” البلاد، وتحويلها لدولة طائفية. ويخشى مركز القاهرة أن تكون مقترحات الجمعية التأسيسية هي الوجه الآخر لما يجري في سيناء، من بروز توجهات انفصالية واضطهاد على أسس دينية. وهو الأمر الذي ينذر بعواقب وخيمة على حقوق وحريات المواطنين والمواطنات، التي انتزعها الشعب في ثورة 25 يناير عبر نضال طويل لعدة عقود وتضحيات عظيمة.
يُعرب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان عن رفضه للفلسفة والرؤية التي تعبّر عنها الصياغات التي انتهت إليها الجمعية التأسيسية في باب الحقوق والحريات والواجبات العامة وباب المقومات الأساسية للدولة. إذ يتجه الدستور إلى تقييد الحريات العامة والانتقاص من حقوق الإنسان، هذا فضلاً عن عدم استيعاب نصوصه لمفهوم الدولة الديمقراطية الحديثة، والسعي لتأسيس دولة دينية تتبنى في دستورها مذهبًا بعينه يمنح المؤسسة الدينية سلطات ذات طبيعة سياسية، وتقوم الدولة الدينية بالأساس على تقييد الحريات العامة والخاصة. كما يُلاحظ تبني الجمعية التأسيسية لمواد تسمح بتعدد النظم القانونية التي تؤطر شئون المصريين، وذلك انطلاقًا من اعتبارات دينية وطائفية. وهي خطوة خطيرة في اتجاه “لبننة” البلاد، وتحويلها لدولة طائفية. ويخشى مركز القاهرة أن تكون مقترحات الجمعية التأسيسية هي الوجه الآخر لما يجري في سيناء، من بروز توجهات انفصالية واضطهاد على أسس دينية. وهو الأمر الذي ينذر بعواقب وخيمة على حقوق وحريات المواطنين والمواطنات، التي انتزعها الشعب في ثورة 25 يناير عبر نضال طويل لعدة عقود وتضحيات عظيمة.
تكشف مداولات الجمعية التأسيسية عن عداء مستحكم لحرية الصحافة والإعلام؛ حيث ما زال الدستور المقترح يبيح إنذار ووقف وإلغاء الصحف. الأمر الذي يهدر نضال مرير للصحفيين والمجتمع المدني ضد فرض تلك العقوبات الجائرة الجماعية في عهد الرئيس الذي أطاحت به الثورة. جدير بالذكر في هذا السياق أنه بعد إعلان الجمعية التأسيسية عن صيغة معقولة للمادة 12 في باب الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تجيز توجيه الاتهام في جرائم النشر إلا عن طريق الإدعاء المباشر، وتلغي العقوبة السالبة للحرية في تلك الجرائم؛ قامت الجمعية بإلغاء هذا النص، وذلك بعد أن أعلن المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين وعضو الجمعية التأسيسية عن رفضه لذلك النص.
يُقيّد مشروع الدستور الحق في تداول المعلومات بدعاوى “الأمن القومي”، وهو مصطلح فضفاض طالما استخدمته الدولة وأجهزتها في حرمان المواطنين، وخاصة الصحفيين والباحثين من الحصول على المعلومات أو نشرها. هذا فضلاً عن الاتجاه الرامي لتقييد حرية التعبير عبر الإنترنت، عبر النص على أن إنشاء وسائط الإعلام الرقمي ينظمه القانون. وهو ما يتزامن مع دعوات صادرة عن جماعات وأحزاب سياسية تُعبِّر عن ضيق الصدر بحرية التعبير عبر الإنترنت والرغبة في تقييدها. جدير بالذكر أن تفويض الدستور المقترح للمُشرِّع بتقييد ممارسة الحق، يتكرر أيضًا في المواد المتعلقة ببناء دور العبادة والتظاهر السلمي.
أما النص الخاص بحرية التنظيم وتكوين الجمعيات فيكشف عن تبني الجمعية التأسيسية لمفهوم جهاز مباحث أمن الدولة في عهد مبارك “عن تعارض حرية المجتمع المدني مع السيادة الوطنية”، وهي ذات المزاعم التي دأبت الحملات الأمنية الإعلامية قبل الثورة على استخدامها لحصار منظمات المجتمع المدني، وتبرير تضييق الخناق عليها؛ بزعم أنها تعمل لخدمة أهداف خارجية. المفارقة أن مبارك لم يجرؤ على وضع ذلك القيد في الدستور أو في القانون؛ ولكن الجمعية التأسيسية، بعد ثورة قامت ضد مبارك ودستوره، قررت تبنيه. إن تلك المادة تتيح لأي حكومة توجيه ضربات استباقية ضد العمل الأهلي والنشاط الحقوقي تحت مظلة الدستور. لقد صِيغ هذا النص خصيصًا لتقييد منظمات حقوق الإنسان المستقلة وتبرير إغلاقها.
ينص مشروع الدستور على أن “تلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير التشريعية والتنفيذية لترسيخ مبدأ مساواة المرأة مع الرجل في مجالات الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وسائر المجالات الأخرى بما لا يخل “بأحكام” الشريعة الإسلامية”. وهو ما يتناقض أولاً مع نص المادة الثانية في الدستور التي تنص على أن “مبادئ” الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع وليس “أحكامها”؛ ويكشف ثانيًا عن رغبة متأصلة في العصف بمبدأ المساواة والانتقاص من حقوق المرأة. إن هذا النص يفتح الباب أمام اعتماد المشرّع على الأحكام الفقهية التي تتضمن عددًا هائلاً من النصوص الفقهية المتفاوتة في تشددها، وهي بطبيعتها اجتهادات بشرية لا إلهية، صدرت في أزمنة سابقة، ولمعالجة مشكلات مجتمعات مختلفة، ومتفاوتة في حظها من التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي. الأمر الذي يؤدي لإخضاع العملية التشريعية لأهواء المفسرين ونزعاتهم الشخصية والسياسية. هذا فضلاً عن أن ذلك النص يعني فرض أحكام الشريعة الإسلامية على المرأة المصرية غير المسلمة. كما أنه يتناقض مع نص مادة أخرى تسمح للنساء غير المسلمات بالاحتكام إلى شرائعهن الدينية فيما يتعلق بالأحوال الشخصية.
يُقيّد الدستور المقترح حرية المعتقد بقصرها حق ممارسة الشعائر الدينية على أتباع الأديان السماوية. وهو نص يميز بين المواطنين على أساس الدين ويهدر الحق في المواطنة المتساوية، برغم أن الهدف الأساسي لأي دستور هو تنظيم العلاقة بين الدولة والمجتمع وليس تبني وسائل لقمع أفراد وجماعات لحساب أيديولوجيات خاصة بالأغلبية السياسية في لحظة وضع الدستور.
وفي باب المقومات الأساسية للدولة يحدد الدستور المقترح لمؤسسة الأزهر دورًا جديدًا، وهو أن تكون المرجعية النهائية في تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع، كما يُعيّن الدستور المقترح مؤسسة الأزهر بوصفها “المرجعية النهائية للدولة في كل الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية، طبقًا لمذاهب أهل السنة والجماعة”. وهي صيغة تتناقض مع بنية الدولة الديمقراطية الحديثة. وفي حال اعتماد تلك المادة بشكل نهائي؛ سيكون الدستور الجديد هو أول دستور يتبنى مذاهب دينية بعينها للدولة المصرية.
تمنح تلك الصيغة المؤسسة الدينية سلطة فوق البرلمان المنتخب ديمقراطيًا والهيئات القضائية المختصة. هذا فضلاً عن أن تلك المادة الدستورية ستدفع بالأزهر لأن يغدو ساحة للصراع والتنافس السياسي؛ للسيطرة من خلاله على العملية التشريعية. إن وضع مؤسسة الأزهر كمرجعية نهائية في تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية؛ يؤسس لدولة دينية تعصف بحقوق الإنسان والحريات العامة والديمقراطية، وهو ما يُذكّر بتدخل الكنيسة في المجال العام في العصور الوسطي بأوروبا، واستخدام دول ديكتاتورية مثل إيران المؤسسات الدينية كمطرقة ضد كل من يعارض حكمها.
جدير بالذكر أن الجمعية التأسيسية الحالية لم تحترم مبدأ الشفافية في أعمالها، سواء مع الرأي العام، أو في العلاقة الداخلية بين مكوناتها من لجان نوعية ولجنة صياغة، وأمانة عامة، ولم تحترم تقسيم العمل المعلن الذي اعتمدته بنفسها. يتبدى ذلك في الموقع الإلكتروني للجمعية، وفي التغييرات المفاجئة في المواد من خلف ظهر الأعضاء –وفق ما اشتكى بعضهم- وفي تناقض بعض المواد المقترحة مع بعضها، وكذلك في تناقض التصريحات والبيانات الصادرة عن كبار المسئولين المعتمدين من الجمعية ذاتها، وهي في مجملها أمور لا توفر المناخ الصحي المطلوب لوضع أول دستور لمصر بعد ثورة 25 يناير. هذا فضلا عن صورية جلسات الاستماع التي عقدتها الجمعية مع أطراف مختلفة -من بينها منظمات حقوقية- داخل وخارج مصر. حيث اتسمت تلك الجلسات بعدم الجدية في التعاطي مع آراء وأفكار ومقترحات المشاركين، الأمر الذي أفرغ تلك الجلسات من معناها وجدواها[1].
في هذا السياق، ومع كل التقدير والاحترام لكل أعضاء الجمعية التأسيسية؛ يلاحظ مركز القاهرة أن المشكلة الأكبر في قوام هذه الجمعية لا تقتصر على عدم تمثيلها مكونات المجتمع المصري بشكل متوازن، ولكن في كونها لا تضم الحد الأدنى من الكفاءات المؤهلة مهنيًا وعلميًا وثقافيًا –بصرف النظر عن خلفياتها السياسية والدينية– لأداء مهمة كتابة مشروع الدستور. حتى إن الأمر يبدو كما لو أن المعيار الأول الذي اعتمد لدى الذين اختاروا تلك الجمعية –أي أغلبية أعضاء مجلس الشعب المنحل ومجلس الشورى– هو إقصاء المؤهلين للاضطلاع بهذه المهمة. إن جمعية يجرى تشكيلها باستبعاد أبرز المؤهلين للمهمة! بالبلاد تكون قد حكمت على نفسها بالفشل، حتى قبل أن تبدأ مباشرة عملها. يستلفت النظر في هذا السياق، أن الجمعية التأسيسية –خلال تفاوضها مع أربعة من أعضائها المنسحبين، لتجنب زيادة عدد المنسحبين منها– قبلت تشكيل لجنة فنية استشارية من خارجها من عشرة خبراء؛ لمراجعة مسودة الدستور وتنقيحها قبل تصويت أعضاء الجمعية عليها. إن مراجعة الأسماء العشرة تطرح سؤالاً بديهيًا، لماذا تجاهلت أغلبية مجلسي الشعب والشورى اختيار هؤلاء الخبراء المؤهلين أو أمثالهم أعضاءً أصليين في الجمعية؟
جدير بالذكر أن أغلبية أعضاء مجلسي الشعب والشورى، كانوا حريصين في اختيارهم لأعضاء الجمعية التأسيسية الأولى –التي حكم القضاء بحلها– والثانية، على ضم عدد من الأشخاص المعروفين بمواقفهم المعلنة والموثقة بأنهم لا يؤمنون بالديمقراطية، أو بضرورة وجود دستور مدني للبلاد، أو بالتزامات مصر تجاه الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، أو بتساوي المصريين في الحقوق والواجبات بصرف النظر عن الدين أو العقيدة أو المذهب أو العرق أو الجنس، أو بعدم مشروعية اغتصاب الأطفال بأي ذريعة.
ويؤكد المركز أن تمثيل هذه التوجهات في الجمعية التأسيسية –بصرف النظر عن الخلفية السياسية أو الدينية– هو ما يفسر تبني الجمعية لأفكار ومواد ومنطلقات شاذة لم تعرفها الدساتير المصرية السابقة أو دساتير الدول الأخرى، مثل تصور أن الله يحتاج مادة في الدستور لحمايته! وكذلك استخدام عبارات ومفاهيم ليس لها توصيف قانوني أو علمي مثل “الشورى” أو “الدولة الشورية”، الأمر الذي يحول الضمانات الدستورية إلى ألعوبة تتقاذفها أهواء المفسرين ومصالحهم الضيقة. كما يفسر حجم تمثيل هذه التوجهات هذا العداء المتفشي تجاه حقوق المرأة والطفل، وحرية الإعلام وتداول المعلومات، والحق في المواطنة، وحرية المجتمع المدني، والحريات الدينية. بل لقد بلغ التراجع في ضمانات بعض هذه الحقوق أن جاء بدرجة أشد تقييدًا مما كان عليه الحال في الدستور الذي هبت ضده ثورة 25 يناير. الأمر الذي يثير سؤالاً منطقيًا، عما إذا كانت رئاسة الجمهورية تعتزم، بعد إقرار مشروع الدستور، الطلب من الأمم المتحدة الانسحاب من عدد من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، أو تجميد التزام الحكومة المصرية بها في حالة تبني الدستور المقترح؟!
إن إحدى أكبر الإساءات التي يمكن أن تلحقها الجمعية التأسيسية بالمصريين، هي تبرير التراجع المريع في دستورهم، باعتباره معبرًا عن “ثقافة المصريين”! إن القائلين بذلك ربما لم تتح لهم الفرصة لتذوق واستيعاب مدى خصوبة وثراء الثقافات الفرعونية والنوبية والقبطية والعربية والإسلامية، ومساهماتها عبر التاريخ في تكوين ثقافة ووجدان المصريين المعاصرين.
إن المصريين بحاجة إلى دستور يرتفع إلى مستوى ثراء ثقافاتهم وحضاراتهم عبر التاريخ، ولا يهبط بهم إلى حضيض التخلف والاستبداد، ويقوّض التماسك الوطني ووحدة البلاد. إن المصريين بحاجة لدستور يصون كرامة المواطن وحقوقه وحرياته الأساسية، ولا يهدر التضحيات النفيسة التي بذلها الشعب المصري في سبيل الانعتاق من ربقة الاستبداد والتمتع بحقوق الإنسان وبالحرية؛ دستور يحمي الحرية لا أن يحمي المرعوبين من الحرية.
[1] لمزيد من التفاصيل؛ برجاء الإطلاع على البيان التالي الصادر عن منظمات حقوقية مصرية حول مشاركتها في جلسات الاستماع التي عقدتها الجمعية التأسيسية: https://cihrs.org/?p=3574#
Share this Post